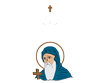مقالات البابا شنودة الثالث المنشورة في جريدة الأهرام – مقال يوم الأحد 7-1-2007
جاء السيد المسيح للكل.. يرفع معنويات الجميع
أهنئكم يا أخوتي بعيد الميلاد المجيد، وببدء عام جديد، راجيًا لكم فيه حياة سعيدة مباركة، ثابتة في محبة الله وطاعته، ومصليًا لأجل بلادنا مصر المحبوبة لكي يمنحها الله الرخاء والسِعة، ويديم عليها الاستقرار والهدوء…
ويسرني في عيد ميلاد السيد المسيح، أن أحدثكم عن بعض ما تركه لنا من أمثولة طيبة، وكيف كان يعمل دائمًا على راحة كل الناس: يحب الكل ويخدم الكل، ويرفع معنويات الضعفاء، ويرشد ويعلّم…
كان قلبًا مفتوحًا للكل، يجول يصنع خيرًا (أع 10: 38).
فيشعر كل إنسان أن له نصيبًا في المسيح
اهتم بالأمم كما اهتم باليهود، وشمل حنانه الأبرار والخطاة، القديسات والساقطات، الأطفال والكبار، والجياع، والمسبيين، النساء والرجال. وبسط عطفه على الفقراء والمحتاجين والجياع، والتعابى والضعفاء. وأيضًا بالمرضى والمصروعين من الشياطين. وفي اهتمامه لم ينس الحزانى على موتاهم. بل إنه لم يغفل حتى مقاوميه فأشفق عليهم…
وقال “تعالوا إليَّ يا جميع التعابى والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم” (مت11: 28).
وقال أيضًا إنه جاء ليعصب منكسري القلوب، وينادى للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، ويعزى كل النائحين (أش61: 21).
نعم، جاء يطلق الذين وقعوا في أسر الشياطين، أو الخطية، أو الأمراض. وكل من كانوا في ضعف أو عجز.
* فمن جهة المرضى: شفى مريض بيت حسدا الذي ظل ملقى في مرضه مدى 38 سنة إلى جوار البركة، حتى قال السيد المسيح “قم احمل سريرك وامشِ” (يو5: 8) فقام وحمل سريره ومشى. وشفى أيضًا المفلوج الذي أنزلوه إليه من السقف بسبب الزحام (مر2). وكان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، فكان يضع يديه عليهم ويشفيهم (لو4: 4). وقيل إنه كان “يطوف كل الجليل، يعلّم في مجامعهم، ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفى كل من يئس من شفائه، ومن عجز الطب في علاجه.
فلجأوا إليه باعتبار أنه رجاء من ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين.. وكان يشفى جميع المتسلط عليهم إبليس.
* فالمصروعون من الشياطين، كان – ينتهر الشيطان فيخرج منهم. وكان بعضهم يصرخ ويقول له “مالنا ولك؟ أجئت قبل الوقت لتعذبنا”. ومن بين الذين شفاهم مريم المجدلية التي كان عليها سبعة شياطين، فأخرجهم منها، فتبعته وصارت تلميذه له (لو8: 2). وشفى رجلًا من كورة الجدريين كانت به شياطين كثيرة (لو8: 30)
* أما عن إقامة الموتى: فقد أقام ابنة يايرس رئيس المجمع (لو8: 41، 55). وأقام إبن أرملة نايين، وكان شابًا وحيدًا لأمه تبكى عليه (لو7: 11، 12). وبين الذين أقامهم أيضًا: لعازر أخو مريم ومرثا من بيت عنيا (يو11)
وكان السيد المسيح حانيًا على الخطاة، ويقتادهم إلى التوبة.
كان لا يعتبرهم أشرارًا، بقدر ما يعتبرهم مرضى. وكان يقول عنهم في رفق: “ما جئت لأدعو أبرارًا بل خطاة إلى التوبة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى” (مر2: 17). وهكذا جعل للخطاة نصيبًا فيه.
ومن هؤلاء الخطاة جماعة (العشارين)، وكانوا محتقرين من الناس في جيلهم، لأنهم كانوا محبين للمال ومشهورين بالظلم. هؤلاء رفع المسيح معنوياتهم أيضًا، واقتادهم إلى التوبة والخلاص. ومن بينهم متى العشار الذي صار فيما بعد واحدًا من الاثني عشر. وزكا العشار الذي دخل المسيح إلى بيته، ولم يبالِ بتذمر الناس لدخوله بيت رجل خاطئ. بل قال لهم “اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضًا ابن إبراهيم (لو19: 9). وفي مثل الفريسي والعشار (لو18: 9-14) أظهر للناس أن العشار في انسحاق قلبه وطلبه للرحمة، كان أفضل من الفريسي المفتخر ببره. لذلك فإن العشار خرج من الهيكل مبررًا دون ذاك..
السامريون كانوا أيضًا خطاة، ولكن شملهم حنانه وعطفه.
وكان اليهود لا يعاملون السامريين باعتبارهم منحرفين عن الإيمان. فحدث ذات يوم أن أحدى قرى السامرة رفضت قبول السيد المسيح. وحينئذ اقترح عليه تلميذاه يعقوب ويوحنا أن يطلب فتنزل نار من السماء وتفنيهم. ولكنه انتهرهما وقال لهما “لستما تعلمان من أي رجل أنتما. لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس، بل ليخلص” (لو9: 51- 56).
وفى مرة أخرى ضرب للناس مثل السامري الصالح الذي أنقذ يهوديًا ملقى على الطريق بين حيّ وميت (نتيجة اعتداء بعض قطاع الطرق عليه). فحمله السامري على دابته، واعتنى به حتى شُفى، بينما كان قد مّر عليه كاهن ثم لاوي، وجازا مقابله دون أي اهتمام (لو10: 30-37). ومازال اسم السامري الصالح يطلق الآن على الهيئات التي تعتني بالغير مهما كان دينه أو عقيدته.
المهم أن السيد المسيح أطال أناته على السامريين حتى قبلوا الإيمان فيما بعد (يو4).
وأيضًا شمل حنانه (الأمم) أي الشعوب غير اليهودية.
وكانوا مكروهين جدًا من اليهود، على اعتبار أنهم يعبدون آلهة وثنية، وأنهم غرباء عن رعوية إسرائيل، بلا ناموس، ولا أنبياء، ولا عهد مع الله (أف2: 13). هؤلاء اجتذبهم السيد المسيح إليه وأظهر أنهم مقبولون أمام الله.
وفى شفائه لغلام قائد المائة الأممي، أعجب بإيمان ذلك القائد، وقال عنه “لم أجد في إسرائيل إيمانًا مثل هذا” (مت18: 10). كما شفى أيضًا ابنة المرأة الكنعانية، وهى من شعب يعتبره اليهود ملعونًا. وقال لتلك المرأة “عظيم هو إيمانك” (مت15: 28)
وبعد القيامة قال لتلاميذه “تكونون لي شهودًا في أورشليم وكل اليهودية، وفى السامرة، والى أقصى الأرض” (أع1: 8). كما أوصاهم قائلًا “اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعلموهم جميع ما أوصيتكم به” (مت28).
كما قال فيما بعد لتلميذه بولس الرسول “ها أنا أرسلك بعيدًا إلى الأمم” (أع22). وقال له في مرة أخرى “كما شهدت لي في أورشليم، ينبغي أن تشهد لي في رومية أيضًا” (أع23). وهى أشهر مدينة للأمم وقتذاك.
وهكذا كان السيد المسيح لكل الأمم وكل الشعوب.
وكذلك رفع معنويات المرأة، وأعطاها مجالًا.
أعطى المرأة مكانةً لم تكن لها في العالم اليهودي. وبارك النساء وخدمة النساء “ونسوة كثيرات كن يتبعنه من الجليل ويخدمنه من أموالهن (لو8: 2، 3)، (مت27: 55). وقد طوّب الأرملة الفقيرة التي دفعت في الصندوق من أعوازها (مر12: 44) كما أنه أقام العشاء الأخير في بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس. وقد تحول هذا البيت فيما بعد إلى كنيسة (أع12: 12)، وكذلك بيت ليديا بائعة الأرجوان (أع16).
وكما اهتم بالنسوة القديسات، كذلك شمل عطفه الساقطات أيضًا. فدافع عن المرأة الخاطئة التي ضُبطت في ذات الفعل، وقال لمن طلبوا رجمها “من كان منكم بلا خطية، فليرجمها أولًا بحجر” (يو5: 7). فلما مضى هؤلاء، قال لها “ولا أنا أيضًا أدينك. اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى”.
واهتم السيد المسيح أيضًا بالأطفال ورفع معنوياتهم.
الأطفال الذين كان ينظر الكبار إليهم في احتقار واستصغار، وينتهرونهم أحيانًا ويطردونهم من طريقه. هؤلاء قال عنهم “دعوا الأطفال يأتون إليَّ ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات” (لو18: 16). وأيضًا رفع طفلًا في الوسط وقال “إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، لن تدخلوا ملكوت الله” (مت18: 3)، يقصد مثل الأطفال في براءتهم وبساطتهم.
وكان يحب الأطفال ويحتضنهم ويباركهم (مر10: 16) ولما انتهروهم وهم يسبحون يوم أحد الشعانين، دافع عنهم بقول المزمور “من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحًا” (مت21: 16). لذلك كله كان يحبه الأطفال ويلتفّون حوله.
كان قلبا عطوفًا على الكل، لا يرفض أحدًا حتى الذين ينتقدونه!
فالفريسيون الذين كانوا يقفون ضده، والذين كانوا يريدون أن يصطادوه بكلمة، لم يمتنع عن زيارتهم وإظهار الحب لهم، وأن لهم رجاء فيه. ولما دعاه سمعان الفريسي، دخل إلى بيته واتكأ… وناقشه ودخل معه في حوار (لو7: 36- 47). مع أن ذلك الفريسي كان قد فتح له باب بيته، ولم يفتح له باب قلبه… حتى الذين صلبوه التمس لهم عذرًا وقال “يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون” (لو23: 34).
وأشفق على الضعفاء والجياع والمرضى
وقال لمن يصنعون معهم إحسانًا -ولو بزيارتهم- “مهما فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي قد فعلتم” (مت25: 40). وفي معجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات، قال لا أستطيع أن اصرفهم جياعًا لئلا يخوروا في الطريق (مت15: 32).
ومن اهتمامه بالفقراء أنه اختار تلاميذه الفقراء صيادي السمك. وكان غالبيتهم من غير المثقفين، ولكنه منحهم من عنده الحكمة والقوة.
وكانت له شعبية كبيرة، باهتمامه بالكل
وكان يعلم الناس أعمق التعاليم، ولكن في بساطة أسلوب يفهمه الكل، الكبير والصغير، الجاهل والمتعلم. وكان في شعبيته يتبعه الألوف وكثيرًا ما كانوا يزحمونه… كان يدخل بيوت الناس، ويدخل إلى سفن الصيادين. يقابل الكل ويكلمهم: في الطريق، وفي المزارع، وعلى الجبل، وفي مواضع خلاء، وعند شاطئ البحيرة.. في كل مكان. ودخل مجامع اليهود أيضًا، وعلّم الناس فيها (لو4: 16- 21).. كان للكل، يعمل لأجل الجميع…
وكل الذين قابلوه منحهم بركة أو نعمة أو إرشادًا. ولم يغلق ذاته على أحد أطلاقًا. وفتح أبواب الخلاص أمام الجميع. ولم يقصر محبته على طائفة أو مجموعة معينة، أو نوعية خاصة من الناس، أو شعب واحد…
كان للكل، للعامي والفيلسوف. كان للصيادين البسطاء كما للوقا الطبيب والفنان، كما لشاول الفيلسوف الذي قرأ الكثير من الكتب وتهذب عند قدميّ غمالائيل معلم الناموس (أع22: 3)… وكل أحد كان يشعر بدالة وصداقة، تربطه بهذا المعلم الصالح وبسماحته ومحبته وحنانه وإشفاقه ومعرفته بالطبيعة البشرية واحتياجاتها…
ختامًا يا إخوتي، هذا الموضوع طويل. فاقتصر على ما ذكرته، وأطلب سلامًا للعالم كله، في الشرق الأوسط، وفي السودان والصومال، وفي بلاد الغرب، وفى فلسطين التي عاش فيها السيد المسيح حوالي الثلاثين عامًا، وكذلك مصر التي مكث فيها ثلاث سنين ونصف
كونوا جميعًا بخير، وليبارك الله هذا العام، ويبارك دولتنا المحبوبة ورئيسها حسنى مبارك، وكل العاملين فيها.